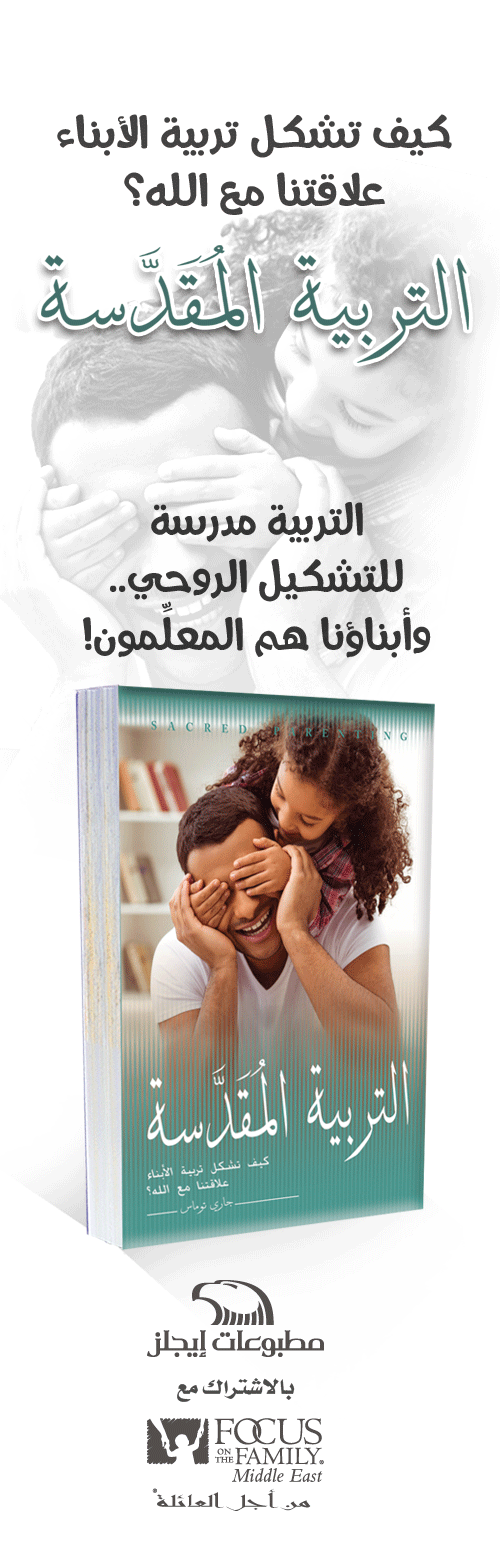بقلم: سامي يعقوب
للمزيد من هذه السلسلة:
كيف ننقل الميراث؟ ١
تربطني بالقُراء علاقة خاصة تحرك فكري ومشاعري، حتى وإن لم نتقابل وجهًا لوجه.. فما أشعر به من اهتمامات أبوية لا أظنه يختلف كثيرًا عما تشعرون به أنتم نحو أبنائكم وأحفادكم.
ومن هذا الواقع أشعر بحرية أن أشارككم ببعض من خبرة حياتي في التعامل مع تحديات التربية، والتي تطورت مع الأيام بالمعرفة والممارسة. لقد تمتعت بعطية تنشأة ابنين، صارا الآن رجلين يافعين، وفي كل مرة أعود بذاكرتي للوراء لأفكر في رحلتي معهما بكل ما فيها من صعوبات وبهجة، أجدها أروع خبرات عمري. ولعل ما يملأ قلب الواحد منا بالسلام والرضا أن ينظر للوراء ويستطيع أن يردد مع الرسول يوحنا إعلان فرحه الذي لا يقارن بأي قيمة مادية: «ليس لي فرح أعظم من هذا: أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق» (٣ يوحنا ٤).
في رحلة تربية الأبناء، من الطبيعي أن يوجد ما يقلقنا بشأنهم، وما يُبهجنا أن نراهم عليه. ومزيج القلق والبهجة هذا يبدأ مع ولادتهم، ويستمر لبقية العمر! فبعد قلق وفرحة الأسبوع الأول لولادة طفل في الأسرة، يبدأ في الحال التفكير في المدرسة، ومن مرحلة الروضة تبدأ معركة الدرجات والتفوق، ولا تتوقف حتى نصل إلى ظلم مكتب التنسيق. ولا يتوقف الاهتمام بالمستقبل عند هذا الحد؛ فبعد التخرج يأتي قلق الوظيفة والحياة العملية، ثم الزواج.. وما يصاحب كل هذه المراحل من تفاصيل. وليس غريبًا بينما يكبر الأولاد أن نصارع كوالدين مع السؤال: «تُرى ما الذي يمكن أن ندخره خلال سنوات كفاحنا لنساعدهم ليبدأوا به حياتهم، ويكملوا الرحلة من بعدنا؟» أو: «أي ميراث سأتركه لأبنائي؟!»
العادة في الصعيد أن تكون مصوغات الجدة والأم من نصيب البنات، بغض النظر عن كيفية توزيع باقي الميراث. المدهش أن هذه الموروثات لا تمثل لأغلبهن هذه الأيام أكثر من قيمتها «كدهب كسر» يُستبدل بثمنه مصوغات «فرفشة» بتاعة «نانسي عجرم»، أو «لازوردي» بتاعة «إليسا»! هذه حقيقة لابد أن ندركها أيًا كانت قيمة ما نورثه لأبنائنا من ماديات، أو ما قد نختاره لهم على غير رغبتهم، ولو قبلوه مؤقتًا لإرضائنا. لذلك لابد أن نفكر في الميراث الذي لا يمكن أن يُباع أو يستبدل، ونهتم بالكيفية التي تجعلهم لا يقبلونه فقط بل يتمسكون به طوال أيام عمرهم!
«الميراث» من الكلمات التي ترتبط في أذهاننا بذكريات تُثير فينا مشاعر تختلف من شخص لآخر.. فقد تذكرنا بخير تمتعنا به، أو بلعنة أصابت أبناء العائلة الواحدة ففرقت بينهم. لكن الميراث الذي أريد أن أبدأ مناقشة متى وكيف نعد أنفسنا لننقله لأبنائنا ليس ميراث المال أو العقارات.. ولا علاقة له بجلباب الوظيفة أو «البيزنس» الذي يحاول البعض أن يورثوه لأبنائهم ليلبسوه من بعدهم! لا، إنه «الميراث» الذي تسلمناه من الآباء، وصرنا وكلاء عليه حتى نسلمه للأبناء، لينقلوه هم بدورهم إلى الأحفاد.
«كيف ننقل ميراث الإيمان إلى أولادنا المستغرقين في ثقافة القرن الواحد والعشرين؟» الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة، ولا أعتقد أن له إجابة نموذجية.. ببساطة لأنها لا ترتبط فقط بنوعية شخصية الابن أو الابنة، بل أيضًا بالبيئة المحيطة بهما كنسيّا، واجتماعيًا، ودراسيًا.
«الإيمان» ينتقل بالعدوى الإيجابية.. أي بتأثير المعايشة، وليس بتكرار الكلام عنه، أو بفرض الاعتقاد به بالترغيب أو بالتخويف. فما يجذب الأبناء ليقبلوا ما يؤمن به الكبار هو ملاحظتهم لما يعيشونه كتطبيق عملي لهذا الإيمان، وثبات التمسك التلقائي بقيم ما نوصيهم أن يعملوه. الأبناء الذين يبهرهم نموذج وقوة إيمان والديهم، واستقامة رفضهم للمساومة على مبادئهم في مواجهة تحديات الحياة المختلفة، هم الأكثر استعدادًا من غيرهم لقبول تعاليم الإيمان المسيحي.. ”المثال العملي ليس طريقة أخرى للتعليم، بل هو الطريقة الوحيدة للتعليم.“ (ألبرت أينشتاين).
مَنْ يقرأ أسفار العهد القديم سيلاحظ أن أغلب نصوصه لا تكاد تخلو من حقيقة أن الـله يريد من شعبه ألا ينسوه! فهو يعرف أن الإنسان عندما تستقر أموره، فينشغل بتحقيق المزيد، يميل بطبيعته أن ينسى من أين جاءته هذه النعم، ويظن أن يديه هما اللتان صنعتا ثروته أو مركزه الاجتماعي! لهذا السبب، تذكرنا الكلمة المقدسة مرة بعد الأخرى أن الـله هو مصدر كل ما في حياتنا من بركات. وحتى يرتبط أبناء اليوم وأحفاد الغد باللـه، لابد لجيل الآباء أن يحرصوا على توفير ما يجذبهم للإيمان به، بقدر حرصهم على توفير كل ما ييسر لهم معيشتهم: «ما سمعناه وعرفناه وأخبرنا به آباؤنا لا نخفيه عن أبنائنا، بل نُخبر الجيل الآتي بأمجاد الرب وقوته، ومعجزاته التي صنع… فيعرفها الجيل الآتي، البنون الذين سيُولدون، ويخبرون بها بنيهم؛ فيجعلون على الـله اعتمادهم، ولا ينسون أعمال الـله، بل يحفظون جميع وصاياه» (مزمور ٧٨ : ٣- ٧ الترجمة العربية المشتركة). والمعنى المحوري في هذا النص أن إيمان الآباء لا ينتقل للأبناء ما لم يقصد الآباء فعل هذا كأولوية تفوق في أهميتها كل ما يفعلونه لأجلهم.
تحكي قصة في الأدب الإسكندناڤي القديم عن عنكبوت غزلت خيطًا مفردًا تدلت به من أحد العوارض الخشبية في سقف مخزن حتى وصلت إلى العتبة العليا لنافذة مفتوحة في جداره. ثم بدأت تنسج بيتها من شبكة خيوط حريرية تتشابك معًا بمادة لاصقة تفرزها، استعدادًا لصيد فرائسها، وجذب أحد الذكور للتزاوج. ومع مرور الوقت بدأت العنكبوت تزدهر ويكبر حجمها، إلى أن جاء يوم لاحظت فيه وجود خيط مفرد يرتفع من شبكتها لأعلى لا تستطيع أن ترى نهايته بسبب غزارة شبكتها.. ولأنها كانت مزهوة بالبيت الذي بنته، نسيت في غمرة انشغالها بإنجازها أن هذا الخيط هو الذي أتى بها إلى غنى تلك اللحظة؛ فقطعته بدون تفكير، فانهار كل عالمها عليها! مثل هذا العنكبوت فعل شعب اللـه مرات عديدة في القديم، ونفعل نحن اليوم عندما ننسى عمل يده غير المنظور في حياتنا عبر الأيام. وإذ ننشغل بتوريث العطية عن الذي أعطاها، قد نصحو فجأة لنجد أن كل واحد من أولادنا يفعل ما يحسن في عينيه.. وهكذا يمضي موسم الحصاد دون أن نتمم المهمة التي أُوكلها السيد الرب إلينا، وما أتعسنا إذا دُفن إيماننا معنا!
«أيها الآباء.. انتبهوا لئلا يسلب فكر وفلسفة العالم الحديث عقول أبنائكم، واصحوا لخطورة أن تسبيهم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي فنفقدهم.. لنلتفت إلى خطورة أن يسيطر عليهم الغرور الباطل للمناصب الوظيفية الرفيعة، ويطمس بريق طموح الدخل الأعلى الإيمان الذي سكن فيهم من أيام طفولتهم؛ لأن كل هذه لا تتفق مع فكر المسيح.» (قراءة معاصرة لما ينصح به بولس الرسول مَنْ يريد أن يُثبت جذور أبنائه في الإيمان.. كولوسي ٢ : ٨ ).
(نُشر بجريدة وطني بتاريخ ١٥ فبراير/ شُباط ٢٠١٥)
Copyright © 2015 Focus on the Family Middle East. All rights reserved