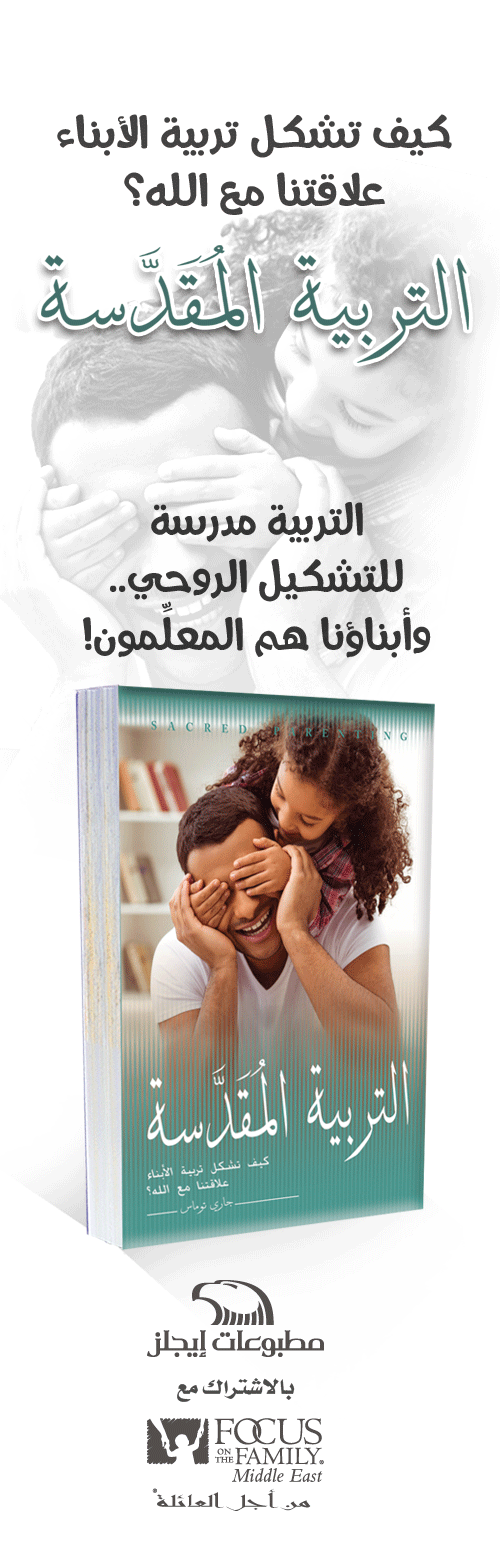بقلم: سامي يعقوب
للمزيد من هذه اللسلسة:
كيف ننمي الثقة بالنفس لدى أبنائنا؟ ١ كيف ننمي الثقة بالنفس لدى أبنائنا؟ ٢
كيف ننمي الثقة بالنفس لدى أبنائنا؟ ٣ كيف ننمي الثقة بالنفس لدى أبنائنا؟ ٤
الأسرة هي المشتل الذي فيه تزرع بذار الشخصية السوية، وفي حضنها تُصقل هُوية الأبناء، ويتأكد شعورهم بالاستحقاق كبشر.. إذن حدود مسؤوليتنا كوالدين تتخطى توفير الاحتياجات الأساسية للأبناء من طعام وشراب، وملابس وتعليم، وعلاج..
فبقدر أهمية هذه الضروريات لحياتهم؛ فإن احتياجهم لبناء تقديرهم لذواتهم، وثقتهم بأنفسهم أهم بما لا يقارن. وبالرغم من إدراك أغلبنا لهذا الأمر، إلا أن النسبة الأقل منا هي التي توازن بين الاهتمام بما يريدون أن يكون عليه أبناؤهم في المستقبل، واحتياجهم في الحاضر لتطوير قدرتهم على التعامل مع ما يواجهونه من التحديات والضغوط التي يمكن أن تبنيهم أو تهدمهم.
ما يبني وما يهدم يرتبط مباشرة بمدى تأثرنا بالمعايير السائدة لتقدير قيمة الإنسان في العالم بصفة عامة ومحليًا بشكل خاص.. الجمال، والقوة، والغنى المادي يأتون على قمة قائمة المقاييس العالمية للاستحقاق. فأفلام كارتون ديزني قدمت الجمال الخارجي للأطفال وكأنه العملة الذهبية والوحيدة للقبول، واختيار الآخرين لهم. كذلك باع لنا نجوم ومشاهير هوليوود وهم الاستحقاق بناءً على ما هو ظاهر، بغض النظر عن جوهر الحياة الداخلية للشخص.. القيم التي تحكم سلوكه.. ثقافته وإيمانه! وعندما نأتي للمقاييس المحلية نجد أننا لم نكتف بما شوهته مقاييس هوليوود، فأضفنا وهمًا آخر لهذه المقاييس.. ألا وهو التحصيل الدراسي والذكاء العلمي، دون أي اعتبار للميول أو المواهب الشخصية للابن أو الابنة، أو لمهارة أحدهم في إجادة علم دون آخر!
لماذا ينتحر الكثير من المشاهير ونجوم السينما؟ وأين هم الآن أوائل الثانوية العامة في السنوات العشرين الماضية الذين «زيطت» لهم وسائل الاعلام وقتها؟ الإجابة الصادقة على هذين السؤالين تكشف لنا مقدار الظلم الذي يقع على أبنائنا بتصنيفهم بناءً على صفاتهم الجسدية، أو دراجاتهم الدراسية.. أما السلوك الأفضل، والتعاون مع الآخرين.. روح المبادرة، والاستعداد لتحمل المسؤولية.. القدرة الخلاقة للتفكير خارج حدود المألوف، فلا تأخذ ما تستحقه من تقدير في مجتمعاتنا! ناهيك عما يواجهه الأبناء في المدرسة؛ فالإجابة الصحيحية على الأسئلة، أو حل المسائل بطرق تختلف عن نموذج الإجابة العقيم لا محل له من الإعراب في مجتمع يفضل الحصول على الدرجة النهائية ولو على حساب الشخصية.. في تجاهل لحقيقة أن تقدم الأمم التي سبقتنا علمًا وحضارة لم يتحقق سوى بنماذج أتيحت لها فرصة التفكير بحرية خارج إطار المألوف.
في المقابل، ما قد يتعرض له الأبناء في داخل الأسرة من مواقف تهدمهم لا تفقدهم فقط ثقتهم بأنفسهم، بل تجرحهم بعمق، وتؤثر على نظرتهم لأنفسهم، وعلاقاتهم مع الآخرين، وأكثر من ذلك تؤثر على فهمهم لمحبة الله لهم! التأديب الذي يحمل إهانة ولو بالكلام، والعقاب غير المبرر.. مناداتهم بألقاب تصف عجزهم أو إخفاقهم، ولو على سبيل الدعابة.. عدم التوازن في ردود الأفعال؛ فنتساهل في مواقف تحتاج للحزم، ونقسو في أمور يمكن تجاهلها.. غياب التشجيع مع وجود قائمة طويلة من الحرمان والجزاءات.. المقارنات مع الأقران، وتفضيل الولد على البنت، الكبير على الصغير، أو العكس.. الحماية المفرطة التي تمنعهم من الاستمتاع بمغامرة استكشاف الحياة، وحرمانهم من تجربة كل جديد.. عدم إتاحة الفرصة لهم ليتحملوا المسؤولية، واتخاذ القرارات نيابة عنهم مع أنها تمسهم شخصيًا.. وفوق كل هذا غياب الحب غير المشروط الذي يؤكد استحقاقهم لا لأي شيء سوى أنهم أبناء.. هذه بعض أمثلة لما يمكن أن يهدم ثقة أبنائنا بأنفسهم داخل جدران بيوتنا! فهل حان الوقت لنجعل من بيوتنا الواحة التي يلجأ إليها الأبناء دائمًا، حيث يجدون السلام يظللهم، والقبول يهدئ اضطرابهم، والتفهم يضع بلسانًا شافيًا على ما أصابهم من جراح، بينما يصارعون مع مقاييس للاستحقاق لا ترحم؛ وهكذا نستغل كل فرصة لنبنيهم؟
موضوع الحكم على الأشخاص بمقياس المظهر الخارجي فقط ليس بجديد.. فعندما أرسل الله صموئيل النبي إلى بيت يسى ليختار من أبنائه ملكًا، ظن النبي أن المهمة سهلة، كما ظن يسى أن الأكبر أو الأطول من الأبناء هو الأجدر بالتعيين الإلهي.. وفي اختبار كشف الهيئة الذي أجراه صموئيل عبر أمامه سبعة من أبناء يسى، الواحد بعد الآخر. وفي كل مرة كان النبي يظن أن الذي أمامه هو الملك الذي اختاره الرب.. لكن الصوت كان يأتيه: «لا تلتفت إلى منظره… لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان؛ فالإنسان ينظر إلى المظهر، وأما الرب فينظر إلى القلب».. وقبل أن يهم صموئيل بالمغادرة، سأل يسى: «أهؤلاء جميع بنيك؟!» فتذكر الأب فجأة أن هناك ابنًا صغيرًا، لم يكن في الحسبان حتى أن يدعى لمقابلة الضيف المهم، فكُلف بأن يبقى في الحقل ليرعى غنم العائلة، ليتيح الفرصة لمن ظُن أنهم الأجدر بحضور هذه المقابلة التاريخية! فأمر صموئيل أن يؤتى به في الحال، وكانت المفاجأة أن الذي أغفل تسجيل اسمه في قائمة المرشحين للمنصب هو مَنْ اختار الله أن يمسحه ملكًا ( صموئيل الأول ١٦: ١ - ١٣).
قرأت مرة عن معلّمة أخذت مجموعة تلاميذها الصغار إلى بستان فسيح لتعلمهم درسًا في الحياة. وكان من بينهم صبي يلقبونه «طيوب»؛ لأنه كان يبدو أقل ذكاءً من أقرانه.. فهو يحتاج عادة لوقت أطول ليفهم الشرح، أو ليجيب على الأسئلة التي تتطلب سرعة البديهة. وفي البستان، أعطت المعلّمة لكل واحد من الصغار قطعة من الحلوى، وطلبت منهم أن يتجولوا في أرجاء البستان بحثًا عن مكان لا يراهم فيه أحد على الطلاق، ليأكلوا الحلوى وهم مختفون تمامًا عن الأنظار ثم يرجعون، والأسرع يكون الفائز! لم يستغرق الأمر دقائق من الجميع لينجزوا المهمة والعودة إلى حيث كانت معلّمتهم تنتظرهم.. وكما كان متوقعًا، فقد غاب »الطيوب» لفترة بدت طويلة جدًا وسط تندر الباقين على افتقاده للذكاء.. لكنه ظهر أخيرًا، وقد بدا من بعيد مضطربًا وهو يهرول راجعًا إلى المجموعة، وعندما اقترب منهم رأوا وجهه مهمومًا لاعتقاده أنه فشل في إنجاز المطلوب، وكان لايزال قابضًا على قطعة الحلوى بكفة يده! ووسط ضحكات واستهزاء مَنْ ظنوا في أنفسهم أنهم الأذكى، قال الطيوب للمعلّمة بتأثر شديد: "لقد حاولت أن أجد مكانًا لا يراني فيه أحد، لكن أينما ذهبت كنت أشعر أن عيني الله هناك تراقبني!“ في رأيكم.. أي نوع من الذكاء هذا؟ أيها الآباء والأمهات ارحموا أولادكم الذين استودعكم الله إياهم.. «الحُسن غش والجمال باطل، والابنة التي تخاف الرب هي الأسعد كل أيام حياتها.. أما الابن الحكيم، فشخصيته تجعله أقوى من كل صاحب سلطة تقوده سبل الحياة ليتعامل معه في مستقبله.» (قراءة شخصية لكلمات الحكمة في أمثال ٣١ : ٣٠، و جامعة ٧ : ١٩ )..
وللحديث بقية نستكملها في المرات القادمة..
نُشر بجريدة وطني بتاريخ ٧ يونيو/ حزيران ٢٠١٥
Copyright © 2015 Focus on the Family Middle East. All rights reserved